أ. د. فيصل الرفوع
كانت ثمانينيات القرن العشرين..ثقيلة ولم تكن نذير خير على أمتنا العربية. ففيها، وتحديداً في 1982، داست سنابك خيول الغزاة بيروت عاصمة الثقاقة والفكر والفن لأبناء العروبة. وقد وقع إحتلالها على جيلنا، كوقع الصاعقة. لأنه، لا عقلنا الباطني ولا الظاهري يمكن له أن يستوعب مجرد فكرة سقوط عاصمة عربية، كبيروت، والتي كانت و ما زالت تئن تحت وطأة قراع سيوف شركاء الوطن والقومية والدين. لكن مصيبتنا بسقوط بيروت تهون أمام أم المصائب، والمتمثلة في سقوط بغداد 2003، عاصمتنا التأريخية، ومركز حضارتنا، وسارية قيمنا، و معين عقيدتنا، ومنارة عزنا، وينبوع مروءتنا، وقبل هذا وذاك، أمنا الرؤم، فبسقوطها، كنتيجة لتحالف الأشرار، هانت كل مصائبنا بما فيها جرح العزيزة بيروت. وفي الثمانينيات كذلك، إشتعلت حرب الثماني سنين المؤسفة بين المسلمين ، إيران والعراق، وإستعرت ولم تتوقف إلا بعد أن أتت على الأخضر واليابس لأهم شعبين مسلمين ، وقبل هذا وذاك، كانت تداعيات « كامب ديفيد» الخلافية تضرب أطنابها في مفاصل الصف العربي وفي وحدة عمله المشتركة.
كذلك، وفي نهاية الثمانينيات، بدأ الربيع الأردني مبكراً (نيسان 1988)، وقبل الربيع العربي بأكثر من 22 سنة ( 10 كانون الأول 2010). في هذه المرحلة المفصلية من تأريخنا العربي، وفي رحاب الجامعة الأردنية إلتقيت معالي المرحوم الأستاذ الدكتور سليمان العربيات، حيث عين للتو عميداً لكلية الزراعة في الجامعة الأردنية.
تزامن ذلك مع تصاعد القناعة والإقتناع لدى القيادة الأردنية بوجوب الإصلاح، وإستيعاب مطالب الرعية المشروعة، والتفاعل مع مخرجات « هبة نيسان 1988» ، ونظراً لبعد نظر القيادة وتحصنها برأي العديد ممن سار معها في الركب وعلى طريقة، كانت العودة للديمقراطية التي أفرزت مجلساً نيابياً، ما زلنا نتغنى بنزاهته وإستيعابه للجميع دون إقصاء او تهميش او قفز على الثوابت. مجلس كان ألأقرب إلى قناعات الناس وخياراتهم، مجلس نيابي أسس للعديد من الملامح الديمقراطية التي ما زلنا نتفيأ بظلال بعضها الذي مازال صامداً أمام رياح الوأد والإقصاء. في هذا الأثناء جاء معالي المرحوم سليمان العربيات في اول حكومة في تلك المرحلة من ديمقراطيتنا الأردنية ،والتي بالرغم من أنها ما زالت تحبو، فإنها نجحت لسبب واحد على الأقل، هو بعدها عن الإيغال في الدم ورفضها للمنازلة خارج لغة الحوار وإحترام الرأي والرأي الآخر، وهذا ما تؤكد عليه ثقافة القيادة الهاشمية.
حين إلتقيت أبو عمر في المرة الأولى، وبدأنا تلمس عالم السياسة و مآلات الفكر و أوجاع الوطن، شعرت حينها، بأن بيننا الكثير من القواسم المشتركة، وأولها التيه القومي والهم الوطني. إلتقينا فكرياً على ثوابت الأمة، وعلى حق أمتنا في الوحدة والتحرر والحياة الكريمة. كانت بغداد تمثل لنا، الأمل الوحيد للأمة، و الملاذ الأخير لنا جميعاً. وضياعها، لا يقل خطورة عن مرحلة ما بعد هولاكو وإبي «رغاله» إبن أبي العلقمي، وهو عين ما يحصل اليوم.
كان الراحل، ابا عمر، صاحب فكر قومي نير، يمتزج ذلك مع ملامح الإنتماء للنقاء الأردني ولقيادته وجيشه العربي ومفاصل أمنه. وطالما سمعت منه « إن تعزيز منجزات الأردن كوطن، هي إضافة نوعية لمقدرات الأمة». كان رحمه الله عاشقاً لأمته العربية، وفي نفس الوقت كان متفانياً في الولاء لوطنه - الأردن. عرفت فيه الجرأة في المواجهة، و بعده عن تقمص ثقافة «المواربة» والتي ما أكثر مريديها في هذه الأيام « النحسة» من تأريخ هذه الأمة الجريحة.
أبا عمر، أنت الآن بين يدي الله، وهو أكرم الأكرمين، فإذا كان ذات يوم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يدخل رحاب الله جلت قدرته.
والله لقد فقدنا برحيلك يا أبا عمر، ذلك الرجل الشهم والمفكر الثابت على العهد ، وقبل هذا وذاك، الإنسان المنتمي لأمته العربية ولوطنه الأردني. فإلى رحمة الله يا أبا عمر، متضرعاً له سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة الأمة على دروب الوحدة والحق والعدل ، وحمى الله الأردن وشعبه وقيادته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
alrfouh@hotmail.com
 أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
 ما قصة إحالة مشروع سكن كريم إلى مكافحة الفساد !!
ما قصة إحالة مشروع سكن كريم إلى مكافحة الفساد !!
 ارتفاع الذهب في السوق المحلية
ارتفاع الذهب في السوق المحلية
 العربيات والطبيشات نسايب - صور وفيديو
العربيات والطبيشات نسايب - صور وفيديو
 حكومة جعفر حسان تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
حكومة جعفر حسان تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
 اعتقال نتنياهو وغالانت: التزام أوروبي ورفض أميركي
اعتقال نتنياهو وغالانت: التزام أوروبي ورفض أميركي
 ضربة إسرائيلية على مبنى سكني في قلب بيروت
ضربة إسرائيلية على مبنى سكني في قلب بيروت
 هل اكتشفت أم محمد هوية الواشي بنصر الله؟
هل اكتشفت أم محمد هوية الواشي بنصر الله؟
 الأردن يحذر من كارثة مناخية وشيكة ويطلب بتحرك فوري .. !
الأردن يحذر من كارثة مناخية وشيكة ويطلب بتحرك فوري .. !

 أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
 ما قصة إحالة مشروع سكن كريم إلى مكافحة الفساد !!
ما قصة إحالة مشروع سكن كريم إلى مكافحة الفساد !!
 ارتفاع الذهب في السوق المحلية
ارتفاع الذهب في السوق المحلية
 العربيات والطبيشات نسايب - صور وفيديو
العربيات والطبيشات نسايب - صور وفيديو
 حكومة جعفر حسان تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
حكومة جعفر حسان تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
 اعتقال نتنياهو وغالانت: التزام أوروبي ورفض أميركي
اعتقال نتنياهو وغالانت: التزام أوروبي ورفض أميركي
 ضربة إسرائيلية على مبنى سكني في قلب بيروت
ضربة إسرائيلية على مبنى سكني في قلب بيروت
 هل اكتشفت أم محمد هوية الواشي بنصر الله؟
هل اكتشفت أم محمد هوية الواشي بنصر الله؟
 الأردن يحذر من كارثة مناخية وشيكة ويطلب بتحرك فوري .. !
الأردن يحذر من كارثة مناخية وشيكة ويطلب بتحرك فوري .. !






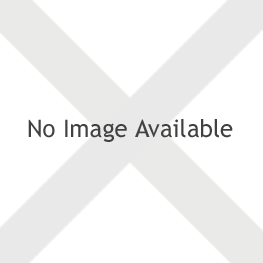
 الرد على تعليق
الرد على تعليق 